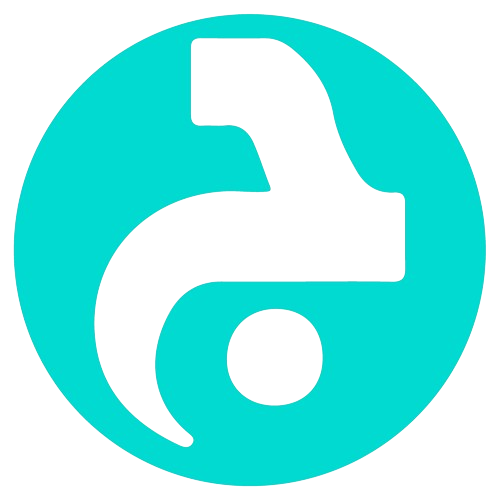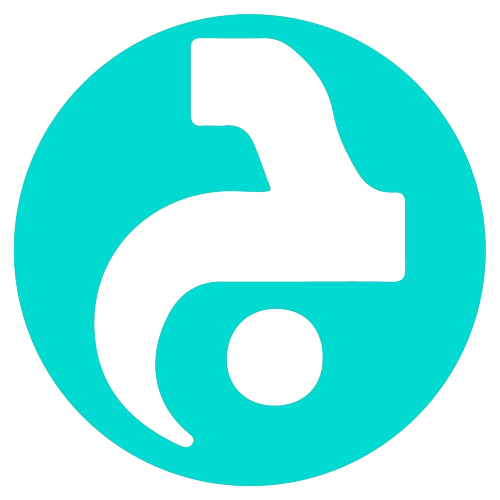في هذا النص تتحدث سلاف_فواخرجي عن مراهقتها وكيف كانت تهرب من أجواء الكبار وهم والديها وأصدقائهم وتنقل إلينا أجواء أمها الشاعرة وصديقاتها الكاتبات من المثقفات والروح الثورية التي كانت تتقد في داخلها وكيف تسللت ذات يوم لتلقي محاضرة على صديقة أُمها الخائفة من التقاليد والعادات وكيف دافعت عن نزار قباني وبرأته من عشيقاته اللواتي كتب فيهن وعنهن الشعر.
النص يشي بقدرة كبيرة عند سلاف لكتابة القصة القصيرة بل يُصنف في خانة القصة القصيرة ولا نعرف إن كانت تملك ملكة كتابة الرواية أو إن كانت جرّبت.
هنا نص سلاف الرائعة، الخالي من الأخطاء اللغوية، والتي يساوي نصها ألف نصٍ لألف كاتب وكاتبة يدعون الأدب وغيرهِ.
تقول سلاف:
كنت في فترة ما يسمى بالمراهقة.. لم تكن تستهويني مجالسة أصدقاء والديَ كثيراً، كنت أرحب بهم كما ينبغي لابنة مهذبة ولبقة، وانسحب بكل هدوء.. إلا أن أصوات أحاديثهم كان تصلني بعضها من بعيد، نقاشات هادئة أحيانًا وحادَة أحيانًا أخرى، في الثقافة والأدب والسياسة والفن وفي الناس وأحوالهم.. ولا أذكر أني تدخلت يوماً في حوار دار ما بينهم. كنت أعيش في عالمي الخاص بي.. بين كتبي وأوراقي ورسوماتي ومسجلتي وشرائط الكاسيت..
ولكن ذات مرة لفتني حديثٌ لإحدى صديقات أمي.. وهي تروي معاناتها عند كتابتها لشعر أو لخاطرة وجدانية ما، حيث كان يُطلب إليها في كل مرة أن تبرر وتشرح وتدافع عن نفسها.. لأهلها، ولزوجها، ولجيرانها، وأحياناً لأصدقائها حتى.
فلا يجب لامرأة أن تكتب عن الحب أو الحلم، أو عن جسد أو قبلة ربما. فتكون بذلك قدمت دلائل وبراهين على جريمتها وخطيئتها التي لا تغتفر.. وأخذت تحكي تلك السيدة كيف كانت تختنق لأن لديها الكثير مما يجول في داخلها تود التعبير عنه، لكن مجتمعها المتخلف كان يمنعها دائما كما قالت، وأن الشك المحيط والمحبِط حولها أتعبها وأنهكها..
فلم أجد نفسي إلا والثورة في داخلي قد اتقدت، فتحت باب غرفتي لألقي عليها محاضرة مفاجئة.. ولأنني أكره شعور الدفاع عن النفس، قلت لها بلا هوادة: أنت كإنسانة لستِ مضطرة للدفاعِ عن نفسك، وكمبدع يشغله الخيال لم تُخلقي لتبرري لأي مخلوق أياً كان..
المبدع خصه الرب عن باقي البشر بخياله، بحلمِه، بروحِه المحلقة، بلا حدود أو خطوط، المبدع لا ينبغي أن يبرر، صاحب الكلمة والفكر والإحساس له مطلق الحرية، وإن خاف وإن تحسب وإن برر، يقتل إبداعه ويتلاشى لا محالة..
وسُقتُ لها ولهم مثالاً مهماً.. أن نزار قباني العظيم لم يعشق كل تلك النساء اللواتي كتب القصائد عنهن، لم يعش تفاصيل الحب بحذافيرها في كل بيتٍ كتبه أو شعرٍ ألفه، لم يعاشر كل تلك النساء إن أحصيناهن، لم يلامسهن جميعهن، لم ير أجسادهن واحدة واحدة ولم يلاعب خصلات شعورهن كلهن.. ولا حتى خنّه حين ذكر أنهن خنّه.
إنه الخيال إنه الإبداع إنه نعمة الله عند نزار وعند كل مبدع..
تكلمت كثيراً ولم أعد أذكر متى وكيف انتهيت.. حل الصمت على كل الحاضرين ولم يصفقوا لي كما توقعت، نظرت إليّ تلك السيدة طويلاً ثم قامت وعانقتني بشدة وحدقت بي مجدداً بعينين يملؤهما الامتنان وكأنني أنا التي أعطيتها حريتها وأطلقت لها يديها.. ومنحتها صك الغفران..
منذ ذلك اليوم وهي تكتب وتكتب وأنا أراقبها وأتابعها وأعجب بها وبفكرها وبجرأتها، وأشعر بالفخر أن لي فضلاً ولو كان خفياً جداً.. أصبحت تكتب دون خوف ولم تعد تهتم لشأن أحد، ليس قلة احترام لمن حولها، وإنما لاحترام ذاتها وما لديها من ملكات، واستطاعت بعد فترة فرض أسلوبها وأدبها، وحتى من لم يعجبه حالها في البداية أصبح معجباً ومشجعاً لها فيما بعد.
مرت الأيام وبدت لي بوادر بسيطة في الكتابة والخواطر وشيئا يشبه الشعر.. وكانت لي آنذاك بعض المحاولات التي احتفظت بها في دفتري الأول الذي سرق للأسف وحزنت عليه أشد الحزن، (ولأنه ليس الشيء الوحيد الذي سُرِق وراح مني فهان عليَ حزني كأمر واقع)
عاودت الكتابة من جديد ولكن بشكل متفرق وخجول، ولما تجرأت مرة ونشرت شيئاً مما كتبت منذ سنوات قليلة، لم أدر بخطورة ما فعلت، استيقظت في صبيحة اليوم التالي على وابلٍ من الرسائل والاتصالات والتساؤلات، عن من؟ ولماذا؟ وهل يعقل؟
وأصبت بخيبة ما، حتى جاءني اتصال من تلك السيدة الكاتبة صديقة أمي التي ذكرتها آنفا، وفرحت لما قرأت اسمها على هاتفي لأنها ستشجعني وتثني علي أو ربما تقول لي بعض الملاحظات التي سأستفيد منها بلا شك..
ولكن خيبتي كانت كبيرة جداً عندما قالت لي، كيف تكتبين وتنشرين وأنت سيدة لك اسمك، وأنت زوجة وأم وغير ذلك فنانة معروفة لا ينبغي لها أن تتكلم عن الحب بهذا الشكل ماذا سيقول الناس، وكيف سيحللون؟! وكيف وكيف وماذا وماذا؟!
وشعرت وكأنني ارتكبت الخطيئة الكبرى _رغم بساطة ما كتبت _
وللمرة الأولى لم تكن ثورتي حاضرة في الرد.. لشدة صدمتي ربما ولأن من تنصحني الآن، كنت أنا يوما ما تلك الطفلة الصغيرة التي جعلتها تتمرد وتتحرر وكنت سبباً بأن يدخل الهواء إلى رئتيها المتحجرتين..
وعدتها لحرصها أن أكتم ما أود قوله.. لأن في ذلك حفاظًا على الصورة المطلوبة مني كامرأة في مجتمعنا..
أقفلت الهاتف وشيئا من نفسي معه، واستنجدت بأمي ورحت أمارس أمامها دور الدفاع: أنا لا اقصد ، أنا ، أنا
ابتسمت أمي كعادتها وقالت لي لا تهتمي ولا تسمحي لأحد أن يخنق صوتك أو يخيفك ولن تنجحي طالما كان إرضاء الناس غايتك..
ولكن يا أمي هذه السيدة بالذات ألا تذكرين عندما…
قاطعتني والبسمة على وجهها بازدياد، ألم يقل حبيبك نزار: “في بلادي، تقف النساء ضد حرية النساء!” قالت أمي..
ارتحت، وأخذت جرعة القوة منها كعادتي..
لكني طمعت بمزيد من القوة فلجأت إلى ابني حمزة، الذي رفض أن أتأثر بما حصل جملةً وتفصيلاً، أو أتوقف عن محاولات الكتابة، وكان من أكثر الداعمين لي، والذي أعاد لي ذاكرتي وهو يقنعني، عندما كنت مثله في ثورة المراهقة والعنفوان.. وربما كان هو أكثر..
هرعت بكل ثقةٍ إلى أوراقي التي لم أستطع استبدالها حتى الآن بـ الوسائط الإلكترونية أو (الكيبورد).. ولكن، جبنت وضعفت.. اعترف بذلك، حتى أنني قمت بفعل غريب عني تمامًا، وخلقت شخصية أخرى واسماً مستعاراً، لأعبر من خلالها عن نفسي.. ولو قليلاً..
ليست هذه الصفحة أو هذا الاسم المستعار بالشيء الخارق أو المميز، ولن تغير كتابتي في تاريخ الأدب، لكني كنت أفرح كالأطفال، عندما أكتب، وأنشر، وأرى كتابتي أمامي في العلن.
جبنت وضعفت.. أعترف بذلك، حتى أنني قمت بفعل غريب عني تمامًا، وخلقت شخصية أخرى واسماً مستعاراً، لأعبر من خلالها عن نفسي، ولو قليلاً..
ليست هذه الصفحة أو هذا الاسم المستعار بالشيء الخارق أو المميز ولن تغير كتابتي تاريخ الادب، ولكني كنت أفرح كالأطفال، عندما أكتب، وأنشر، وأرى كتابتي أمامي في العلن.
ولم يكن يهمني عدد ردود الأفعال القليلة جدًا من دائرتي الصغيرة العالمة بالأمر.. فليس في العدد سعادتي.. بل في نعمة التعبير.. ففي فعل التعبير بحد ذاته تكمن سعادة لا يمكنني وصفها أو شرحها.. وخصوصاً أنني من الذين تعنيهم الكلمة والمفردة واللغة والتعبير وتؤثر بهم..
وبعيداً عن تقييم الكتابة وإعطائها درجات كنت أفرح بها لأنني كنت أنا.. ببساطة كنت أنا..
لا أكذب ولا أتجمل ولا أخاف..
وبعد فترة ليست بالقليلة، وحين كنت أسمع أحياناً بعض الإطراء.. بدأت أشعر بالغيرة..
نعم لقد شعرت بالغيرة من تلك التي تنال الإطراء عوضاً عني.. من ذلك الاسم الذي خلقته يوماً لأداري جبناً حلّ بي وتملكني..
لم أكرهها.. فأنا من أحياها، ولكني عشت صراعاً معها، لماذا هي حرة أكثر مني، لماذا هي لا تخاف، لماذا لا تقيدها السلاسل والأحكام والوصاية مثلي.. تمنيت أن أكون مكانها، أن أكون هي، ولكن هي أنا.. عندما أكون أنا..
واكتشفت أني أكذب وأتجمل وأخاف!
وقررت أن أقف أمامها، أن أواجهها، أن أمنع عنها الإطراء والمجاملات وعبارات المديح وإن قلّت، كي لا تصدق نفسها أكثر، وتعيش تفاصيل الكذبة وتشعرني أني أقل منها، كي لا تضحك وتشعرني بنشوة الانتصار، وهي تكتب عبارات الحب بينما أنا أدور حول نفسي وأنسى مفرداتي وأبحث عن عبارات التبرير التي لا تنتهي..
جعلتني الغيرة أقف مع نفسي مطولاً، وأن أكسب المنافسة لصالحي، أن أكون أنا. وببساطة وبحق، كما طلبت إلي أمي يومًا ما ودائمًا، وكما يريدني ابني حمزة أن أكون.. لا وصاية ولا من يحزنون…
بعدها أحببت نفسي أكثر وتصالحت مع تلك المرأة الجميلة ذات الاسم المستعار، واتفقنا أن نكون شخصاً واحداً حراً صادقاً..