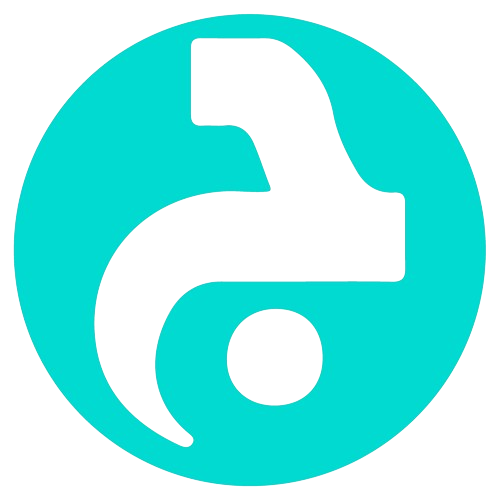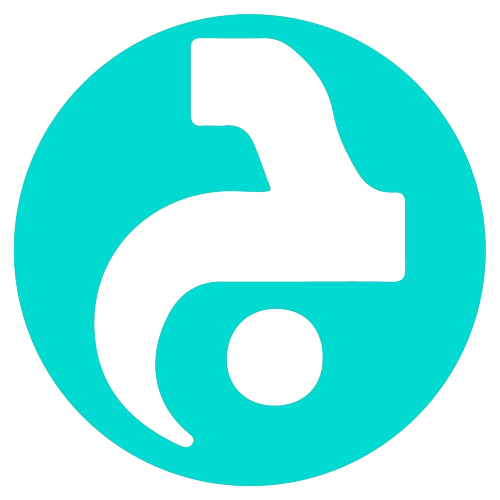ووالداي ومن حولهما، منحاني إسماً لم أختره، وأسلوب عيشٍ لم أختره، وديناً لم أختره.
وأنتم كذلك.
لقد وجدنا أنفسنا على ما اعتدنا عليه.
والعادة ليست أقوى من الخيار، بل هي عكس ما يروِّجون لعظمتها وجبروتها.
كل الحكاية أن العادة أسهل وأقل كلفة من الخيار.
كلٌّ منا يعتقد نفسه أنه من أهل الدين الذي وَجد نفسه فيه أو عليه.
والصحيح أننا لسنا من أهله، بل من أتباعه قسرًا وبالقوة وبالسيف والعادة.. وبأي شيء ألا الخيار.
ديننا ليس خيارنا، بل قوة ديكتاتورية قهّارة مصدرها الأهل والمرجعية الدينية السياسية التي تدعس الأهل.
كلٌّ منا يعرف أنه ليس مسيحياً، ولا مسلماً ولا درزياً، ولا يهوديًا ولا بوذيًا ولا هندوسيًا، لأنه لم يختر دينه.
ورغم ذلك فإن أحداً لم يقرر أن يثور على واقعه ليرتقيَ بنفسه عن كونه عبداً ذليلاً يخاف أن يقول لا، وأن يقول أنا لستُ ملكاً لمعتقداتكم، وأريد أن أفهم ما الدين الذي أتّبعه بقوة سلطتكم.
ولأننا لم نرتقِ بأنفسنا، فلم نقرأ ديننا لنوافق عليه أو لا نوافق، فخرج علينا رجال الدين ليجدونا عراةً من معرفة الله، فاستعبدونا.
(ليس أسهل من استعباد الجاهل الخائف).
رجال الدين آلهة المال، ونحن عبيدهم، لا عباد الله الواحد الأحد.
نحن عبيد أفكارهم ومذاهبم وقواميسهم وأعرافهم وطقوسهم التي قتلت الله، واحتلت كرسيّه، وبطشت فينا، إلى أن تحوّلنا من مخلوقات كاملة قادرة على أن تحرّك بنظرة منها، هذا الجبل من هنا إلى هناك، (كما قال يسوع)، إلى مخلوقات عاجزة عن النظر في عين بطّاشٍ، تسلّح بأكسسوارات النصب والإحتيال، ليزجر فينا ويقرّر ماذا نريد وكيف.
في عجقة العنف الديني، ضاع الله منّا، خبّأوه تحت جلابيبهم، ولا نجرؤ على الوصول إلى رؤوسهم كي نستعيد إلهنا.
منذ ولدنا رتّبوا أحوالنا الشخصية والعامة في صناديق، فكبرنا عاجزين عن التسلل من «البوكس» أو الصندوق، كي نذوب في لعبة الحياة، وكي نكون أحراراً نعبث فيها، نحب، نكره، نثق، نشك، نلهو ونتعب، نبحث ونعرف ونعشق الله.
بنوا الكنائس والجوامع والمزارات وسمّوها بيوت الله، وأصبح لدينا بيوتات «تلملمنا» كي يُسهِّل عليهم احتواءنا وسرقتنا والبطش بنا، حتى أبشع أنواع الذلّ.
حتى صار وباسم الله، يأكل رجلٌ قلبَ رجلٍ من أهل دينه وبلده.
ومندوب الله، يغرق في نشوة سلطته، يضع جزمته فوق رؤوسنا، نركع خاضعين، وله نُهبِط رؤوسنا، لتصبح بمحاذاة نعلِهِ، وهكذا نقتل السماء.
نحن مُلكية لسيد الطائفة، نردّد خلفه ما يتفوه، نبكي إن بكى، نصفق إن حكى، نزغرد في حفل تطهير عضو إبنه الذكر، ونناديه بالسماحة والفضيلة والسعادة والنيافة والقداسة والحِبر والمفتي.
هذا يحدث لنا منذ مئات السنين والله لا يتدخّل.
ورغم أن الله لا يتدخل، فإننا نتهمه!
نصفه بالقاتل المجرم، لكن بعبارات محتالة، فنقول مثلاً: (إن الله قدّر وشاء).
منذ وعيت، لم أسمح لقتلة الله أن يعدموه فيّ، كنت ولا أزال أتأمل فيه وأسأله بعد كل كارثة، كيف يستطيع أن يتحمل بغال الأرض، واتهاماتهم بأنه يشاء الذبح والفقر والتعذيب والإغتصاب والتنكيل؟
وكيف يُقدّر الله كل هذه الجرائم؟
هل يخلقنا ليقتلنا وينكّل بنا؟
هل يخلقنا ليهدّدنا فيعدنا بالمشانق ويُمرضنا ويسرق إنسانيتنا؟
هل يحتاجنا الله أدوات ليمارس ألوهيته ضدّنا؟
أم أن الله أعطانا كل القدرة لنعيش كل النعيم، ولم نقدّر ما قدّر؟
فانقلبنا عليه واستبدلناه بمن عمّروا قصوراً دينية ليحكمونا فيها وبها.
ألا يجدر بنا الإعتقاد أن لله حكاية أخرى، غير تلك التي تجعل بغال الأرض تعبد من يدعون أنّهم رجاله وتقدّس من يعتقدون أنّهن نساؤه.
نستطيع أن نستعيد الله فينا، لكن ليس قبل أن نعدم مندوبيه على الأرض.
علينا تبرئة الله، والكف عن اتهامه بأنه (قدّر وشاء).
نحن من يشاء، وهو من ينفّذ مشيئتنا.
وإن لم يكن ما أهذي به صحيحاً.. إذن، كيف يحقّ لله أن يحاسبني على تقديراته هو، ومشيئته هو وأفعاله هو!؟